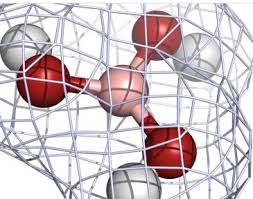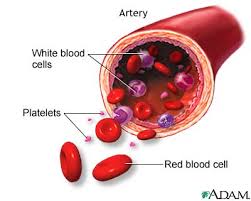بحث قصير عن الصبر , فقرة عن الصبر للاذاعة المدرسية كلام عن الصبر
يعتبر الصبر من أوضح المصطلحات والمفاهيم الإسلامية وأجلّها. وقد استخدم في النصوص الإسلامية في العديد من الموارد وطرح بأساليب وطرق تتناسب مع القضايا المختلفة بما تضمنه من أجر وثواب وإشارة إلى أهميته.
وعندما يطرح في الأحاديث، فمن الطبيعي أن يحرك المسلم ويبعث في نفسه الرغبة للتعرف إليه والسعي للاتصاف به.
وللأسف، فقد تعرض هذا المفهوم ـ كغيره من المفاهيم ـ للتحريف الذي ابتليت به أغلب المفاهيم الإسلامية، ويمكن القول بخصوص مفهوم الصبر أنه مسخ وحرف معناه، فانقلب رأساً على عقب.
الفهم الشائع والعامي للصبر
يعرَّف الصبر عادة بأنه تحمل الآلام والمرارات. وهذا التعريف والفهم يمتزج بالإبهام والغموض إلى حد كبير بحيث يسمح لكل من يريد، أن يوجهه إلى معانٍ مختلفة، بل متضادة. فإذا طُرح مفهوم الصبر في مجتمع ـ يعيش الظلم والقهر، ويخضع لأشكال الفساد والانحلال ـ بشكل خاطئ، يتحول إلى عامل مهم يستخدمه الظالمون والمفسدون للاستمرار في السيطرة والقمع، ويصبح عاملاً مساعداً للتخلف والركون وبقاء حالة الفساد والانحطاط. وعندما يطلب من شعب يعاني الفقر والحرمان والتخلف أن عليك الصبر، وهو غائص في مستنقع الضياع والانحراف أو غارق في المظالم التي تتسبب بها زمرة الظالمين عديمو الشرف والإنسانية، فإن أول ما يفهم من هذه الموعظة كإجراء عملي أن عليهم تحمل المرارات والآلام والظروف القاسية المهلكة التي تمارس وتفرض عليهم. وتكون النتيجة أيضاً أن هذا المجتمع ليس أنه لن يتحرك نحو الثورة ضد الأوضاع السيئة للتخلص والنجاة من هذا الظلام والضياع فحسب، بل سيتوهم ويمني نفسه بأنه مأجور ومثاب عند الله على هذا الصبر أيضاً وعليه، ينزوي ولا يبالي بما يحدث ولا يكترث بما يحصل حوله، ويعيش حالة من الرضا والسرور ويظن ذلك فوزاً عظيماً له.
ومن الواضح أنّ شيوع وانتشار مثل هذه الروحية في المجتمع سيعود بنفع كبير على الطبقات الظالمة التي تريد الحفاظ على امتيازاتها. ويبقى الضرر نصيب الطبقات المستضعفة المظلومة.
ومن المؤسف أنّ هذا الفهم الخاطئ المستلزم لهذه الآثار والنتائج في المجتمع، يطغى في عصرنا الحالي على المجتمعات الإسلامية. كما أن طرح أي معنى آخر للصبر ـ وإنْ كان مقبولاً ومنطقياً عند من لم يُسبق بالتعرف إلى هذا الموضع ـ يحتاج إلى الكثير من المقدمات والأدلة لأولئك الذين لم يتعرفوا إلى التعاليم والمعارف الإسلامية بشكل صحيح. وقد يكون البحث معهم في أغلب الأحيان لا طائل وراءه.
وإذا أردنا الاطلاع على الآيات والروايات التي تناولت مفهوم الصبر بشكل جامع وشمولي، فإننا سنتعجّب بعدها من هذا التحريف النبوي الذي قد وصل إلى درجات خطرة.
نظرة عامة على المصادر التي تطرح الصبر
إذا فهمنا معنى الصبر وتبيّن لنا وفق ما طرح ـ بوضوح ومن دون شائبة ـ في الآيات القرآنية والروايات المنقولة عن الأئمة (عليه السلام) سنصل إلى نتيجة تخالف كلياً ما هو رائج وشائع بين الناس. وعندما ننطلق من الرؤية القرآنية والروائية سنشاهد أن الصبر هو ذلك العمود الحديد الذي يقلب أكبر الصخور وأثقلها، ويقوم برفع الموانع والعواتق الكبرى، ويواجه المشكلات ويتجاوزها بكل سهولة محققاً النتائج الإيجابية تماماً.
وحينها سيكون مفتاحاً لكل أبواب السعادة والخير للمجتمع المظلوم والضال. كما كان من الممكن أن يكون مفتاح أبواب الشقاء والتعاسة للمجتمع بأسره. وبفهمه فهماً صحيحاً فإنه سيغدو المانع والرادع والمقلق لكل القوى الشريرة السيئة.
وللتعرف إلى مفهوم الصبر ومضمونه وميادينه التي يكون فيها الحل الوحيد المفيد والنافع، علينا الرجوع إلى القرآن وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) والوقوف عليها والتدقيق فيها. فحينها يمكن إثبات المعنى الصحيح لهذا المفهوم. أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فقد أتى على ذكر الصبر والصابرين في أكثر من سبعين آية بشكل مباشر وصريح مع مدح هذه الصفة والمتصفين بها، كما ذكرت الآثار والنتائج القريبة لها والمواقع التي تزيد وتكبر الأمل في الذين يتمسكون بها. ولكن، لن أتعرض في هذا البحث المختصر إلى الآيات القرآنية وشرحها، بل سأكتفي بالتدقيق في الروايات واستنباط المعاني والدلالات منها. وانتهاجي هذه الطريقة مردّه إلى أمرين.
الأول: إن الوقوف والتدقيق في الآيات القرآنية التي تناولت مفهوم الصبر يستلزم الدخول في بحث واسع ويحتاج إلى فرصة أوسع.
الثاني: اعتمادنا على الروايات يساهم في رفع النسيان والإهمال الذي تعرضت له أحاديث المعصومين حيث خلت الأبحاث والدراسات الإسلامية الأخيرة منها، ويبيّن كيفية الاستفادة من روايات الشيعة لأولئك الذين لم يطلعوا على الدور الوضّاء والهادي للحديث.
المفهوم الإجمالي للصبر
بناءً على مجموع الروايات التي وصلتنا، يمكننا أن نعرّف الصبر بهذا النحو: هو مقاومة الإنسان المتكامل (السالك طريق الكمال) للدوافع الشريرة المفسدة والمنحطة.
وكمثال على ذلك يمكننا أن نشبّه هذا الأمر بشخص يريد تسلق جبل. فأثناء تسلقه للوصول إلى القمم العليا يوجد موانع مصاعب، قسم منها يتعلق بهذا المتسلَّق وينبع من نفسه، والقسم الآخر يرجع إلى العوامل الخارجية، فيعملان معاً على الحد من حركته.
أما ما يرجع إلى الإنسان نفسه، فهو طلب الراحة والخوف أو اليأس من الوصول إلى الهدف، والأهواء المختلفة التي تعمل على منعه من الاستمرار في التسلّق والصعود، حيث تنخفض حرارة الاندفاع والبواعث بسبب استمرار تلك الأفكار والوساوس. أما فيما يرجع إلى العوامل الخارجية، فهناك الصخور الضخمة والذئاب والأشواك وقطاع الطرق وأمثالها. كل منها يهدد الإنسان ويمنعه من متابعة مسيرة. ومثل هذا الشخص الذي يواجه هذه المتاعب والمصاعب إمّا أن يقرر عدم مواصلة السير بسبب المخاطر والآلام والمشاق، وإما أن يصبح الأمر عنده معاكساً، حيث يزداد عزمه قوة وثباتاً، ويقرر أن يقاوم جميع الموانع الداخلية والخارجية، وبالاعتماد على عامل المثابرة والتحمل، يدفع هذه الموانع من طريقه ويواصل المسيرة.
هذا الثاني هو الذي يعني الصبر.
والإنسان في حقيقة حياته المحدودة في هذا العالم وفي الواقع، قد جُعل في طريق ـ يمتد من بداية حياته الدنيا وحتى وفاته ـ وليسلكه ويطويه نحو الوصول إلى أعلى منزل من منازل الإنسانية. ولأجل تحقق هذا الهدف، ولكي يقترب من هذا المنزل، خلق لأجله كل ما يعينه عليه. وكل هذه الوظائف الملقاة على عاتقه والتكاليف التي كلف بها تعد وسائل القرب والمراحل السير نحو الهدف المنشود. ولم يكن ذلك المجتمع الإسلامي، الذي يعد أول هدف للدين الإلهي والأنبياء العظام إلا لأجل بناء ذلك الإنسان الواصل وصناعته. فهم (صلوات الله عليهم) كانوا يريدون إيجاد المناخ المناسب لتمكين الإنسان من سلوك هذا الطريق بيسر للوصول إلى تلك الغاية.
إنّ هذه الغاية يمكن التعبير عنها بكلمات قليلة، فهي تعني ارتقاء الإنسان وتكامله وتفجّر ينابيع الاستعدادات والقابليات المودعة فيه. وهذا ما يعبّر عنه في ديننا أيضاً بتعبيرات مختلفة من قبيل “التخلّق بالأخلاق الإلهية، والقرب من الله و…”.
وبالطبع يوجد في هذا الطريق، الذي هو طريق صعب مليء بالمتاعب، موانع وحواجز كثيرة، على الإنسان أن يقطعها ويجتازها. وإنّ كل مانع منها يكفي لوحده لإيقاف هذا المتسلِّق نحو قمّة الكمال والرقي ومنعه من متابعة سيره.
فمن جانب باطن الإنسان يوجد كل تلك الصفات والخصال السيئة والرذيلة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية الدنيوية التي تجلب المتاعب والآلام وتعتبر مجموعة من الأشواك والعقبات في هذا الطريق.
الصبر هنا يعني مواجهة ومقاومة كل هذه الموانع بإرادة صلبة وعزم راسخ يضع كل هذه العقبات جانباً. وكما ذكرنا، فإنّ جميع التكاليف الإسلامية الفردي منها والاجتماعي تُعد وسائل ولوازم هذا الطريق للوصول إلى المقصد الإنساني. وبناءً عليه يكون كل واحد منها بذاته مقصداً وهدفاً قريباً ينبغي تحقيقه للوصول إلى الغاية النهائية. فالذي يريد السفر إلى مدينة بعيدة، فإن الأماكن التي تقع في مسيره، وكذلك إعداد اللوازم ومتطلبات السفر، هي بمثابة الأهداف والمقاصد القريبة التي ينبغي الوصول إليها كمقدمة نحو الهدف النهائي والأساسي. ففي نفس الوقت التي تعتبر تلك المقدمات وسيلة للوصول، هي أيضاً غاية ونتيجة لتحقيق مقدمات أخرى. وما أريد أن أصل إليه من هذا الكلام، هو أن الوصول إلى كل واحد من هذه الأهداف القريبة يتطلب شرطاً أساسياً أيضاً، وهو الصبر الذي يعد كالحربة الحادة القوية التي تمزق كل ما يمنع من الوصول إلى المطلوب. وكما أن على طريق الهدف النهائي يوجد موانع كثيرة، كذلك هناك موانع عديدة (داخلية وخارجية) تقف عائقاً أمام الأهداف القريبة وتشكل العقبة المواجهة لتطبيق كل واحد من التكاليف والوظائف الإسلامية.
ومن جملة العوامل المؤدية إلى الركود والخمود فيما ينبع من نفس الإنسان هناك الكسل وروحية القيام بما هو سهل فقط، وحب النفس والغرور، والحرص وحب الرئاسة والجاه، والتكاثر بالأموال والشهوات وغيرها من الصفات والخصال الخسيسة. ومما ينبع من العوامل الخارجية هناك الأجواء والبيئة المعيقة وغير المناسبة والمشاكل وتبعات بعض الأنظمة الاجتماعية الحاكمة. فكل واحدة من هذه العقبات تؤثر في منع الإنسان من أداء التكاليف الإلهية البناءة، سواء منها التكاليف الفردية كبعض العبادات أو التكاليف الاجتماعية كضرورة السعي لإعلاء كلمة الحق.
إن ما يبطل تأثير العوامل السلبية، ويضمن القيام بكل التكاليف الإلهية واستمرار السير على الطريق الصحيح، هو المقاومة الإنسانية، أو مواجهة الإنسان للموانع المذكورة. هذه المقاومة أو المواجهة هي التي تعني الصبر.
موقع الصبر وأهميته في الروايات
عند الرجوع إلى بعض الأحاديث التي تدور حول الصبر نجدها تحكي وتدل على أهمية الصبر في الإسلام والشرائع الإلهية كافة، حيث يمكننا أن نلخص التعبير عن هذه الأهمية بهذه الجملة وهي أنه كان وصية جميع الأنبياء والأولياء والقادة الحقيقيين لأتباعهم وخلفائهم وكل من يسير على دربهم.
إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الأب الرحيم والمعلم الشفيق الذي أمضى عمره في السعي والجهاد متحملاً لكل الآلام في سبيل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه، نرى أنّه في اللحظة التي يودع فيها هذه الحياة الدنيا، وعندما تصبح يده عاجزة عن متابعة العمل والسعي وبذل الجهد للوصول إلى الهدف الذي صرف عمره من أجله، فإنه يعهد إلى وارثه لأجل المضي به وإكمال المسير نحوه ويوصيه بما يمكّنه من بلوغ ذلك المقصد الأسمى.
فما هي هذه الوصية الأخيرة الذي ينطق بها إلى وارثه الذي أوكل إليه أمر هذه المهمة الخطرة؟
إنه لن يقول له إلا ما هو عصارة تجاربه كافة، وسيقدم له ثمرة سعيه العلمي والعملي، ساعياً لتبيين ذلك في جملة تختصر المطلوب، ضمن وصية تختزن بداخلها كل المعارف والإدراكات القيّمة لتتحول إلى هاد ومرشد دائم لذلك التلميذ الوارث، وكأن النقطة النهائية في حياة الأول تصبح نقطة بداية تكامل وارتقاء للتالي.
بعد هذه المقدمة نرى أن آخر وصية للأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وبناة المجتمع الإلهي السامي وآخر هدية فكرية قدموها لخلفائهم هي الوصية بالصبر.
وننتقل الآن إلى محطة نتوقف فيها عند حديثين مرويين عن أهل البيت (عليهم السلام) في موضع الصبر. الحديث الأول عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): “لمّا حضرت الوفاة أبي علياً بن الحسين ضمّني إلى صدره وقال: “يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ـ وبما ذكر أنّ أباه أوصاه ـ يا بني، اصبر على الحق وإن كان مرّاً”(1).
وفيما يتعلق براوي الحديث فهو أبو حمزة الثمالي من خواص الأتباع الخلّص لأهل البيت (عليهم السلام)، وكان من العناصر الأساسية في جبهة الدفاع عن التشيع. لذا ما نقله عن الإمام الباقر (عليه السلام) صحيح معتبر.
لقد خلَفَ الإمام الباقر (عليه السلام) أباه الإمام السجاد (عليه السلام) حاملاً أمانة الحفاظ على ميراثه ومتابعة طريقه ومشروعه. وكان وجوده (عليه السلام) استمراراً لوجود أبيه (عليه السلام) الذي كان بدوره استمراراً لوجود الإمام الحسين بن علي (عليه السلام). فكل واحد من أفراد سلسلة الإمامة كان يمثّل استمرار مشروع السابق له، وكانوا جميعاً استمراراً لوجود النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم). لقد كانوا جميعاً نوراً واحداً ونهجاً واحداً يرمون تحقيق هدف واحد.
وإذا عدنا إلى الحديث نجد من عبارة “يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة” أن المشار إليه هو الإمام الحسين (عليه السلام) الذي نعلم جميعاً أين كان وبأية حالة، حين حضرته الوفاة.
ففي تلك الأجواء الشديدة ليوم عاشوراء ووسط بحر الآلام والمصائب وفي هذه الظروف الدموية التي خيمت على كربلاء، والأعداء يحاصرون معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)، نجده يستفيد من فرصة صغيرة قبل أن يحمل حملته الأخيرة على معسكر الأعداء، فيرجع من ساحة القتال إلى معسكره ويعقد لقاءاً قصيراً مع أفراد أسرته الذي من المفترض أن يواصلوا ثورته ويتابعوا نهضته، ويتحدث من ولده وخليفته علي بن الحسين (عليه السلام)لمدة قصيرة، لكنّها مهمة جداً ومليئة بالفائدة، وهذا ما يُعبّر الناس عنه بالوداع الأخير. والإمام ـ كما ينبغي أن نعلم ـ معصوم لا يقع تحت تأثير العواطف إلى درجة أن يضيّع هذه الفرصة الأخيرة من حياته بكلام غير مهم مقتصراً في وصيته على المسائل الشخصية أو العاطفية. فهذا لا ينسجم مع الوصايا التي وردتنا من الأئمة العظام (عليه السلام) ولا يشبهها!!
والإمام المعصوم (عليه السلام) يعلم أنّ في هذه الساعات الحساسة الباقية من عمره، ينبغي أن يودع هذه الأمانة التي سعى جاهداً من بداية إمامته لحفظها، متحملاً كلّ الآلام والمصائب العظمى، كما فعل مؤسس الثورة الإسلامية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والإمام الحسن (عليه السلام) من قبله. ولهذا، عليه أن يعهد بهذا الحمل إلى شخص يأتي من بعده ذي قوة متين ثابت القدم ليخلفه. فنراه يأتي إليه ليوصيه بأهم وصية، تساعده على حمل وحفظ هذه الأمانة. ماذا كانت تلك الوصية المهمة والنفيسة؟!
نجد الإمام علياً بن الحسين (عليه السلام) ـ الذي، وإن لم تكن حالة شهادته كشهادة أبيه الحسين (عليه السلام)، إلاّ أنّه كان يعيش في ظروف مشابهة ـ يكشف النقاب عن تلك الوصية التي أوصاه بها أبوه (عليه السلام) ويعيدها على مسامع ولده الإمام الباقر (عليه السلام) كوصية أخيرة له. ويذكر ضمن ذلك أن هذه الوصية قد نقلها أبوه (عليه السلام) عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام). هذه الوصية التي انتقلت عبر السلسلة الطاهرة للإمامة، وكان كلّ إمام يوصي بها الإمام الذي بعده، هي الصبر: “يا بني، اصبر على الحق وإن كان مرّاً”.
إنها تطلب منه أن لا يتردد أثناء سلوك طريق الحق، ولا يعير اهتماماً للموانع والعقبات. وإذا تم تشخيص العمل المطلوب في هذا الطريق فلا يرفع يده عنه، طالبة منه التحمّل والاستمرار.. ومن الواضح في ساحة المواجهة بين الحق والباطل أنّه لا وجود للراحة واللذة والعيش الهنيء، وإنّما المحن والبلاءات والمصاعب “وإن كان مُرّاً”. هذه هي الوصية التي انتقلت من إمام إلى آخر. وشاهدنا كيف كان الأئمة (عليهم السلام) يعملون بها ثابتين عليها حتى آخر لحظات حياتهم، متقبّلين لكلّ العواقب التي تحملها إليهم، وكانوا حقاً مصداقاً بارزاً لهذا البيت الشعري الجميل:
سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمرّ من الصبر
وإذ تبيّن لنا من كلّ ما ذكرناه في الحديث الأول، أهمّية الصبر وموقعه في التعاليم الإلهية كجوهر نفيس وميراث غال طبّقه الأئمة (عليه السلام) طوال حياتهم، ننتقل إلى الحديث الثاني المروري عن أهل البيت (عليهم السلام) وقد ورد في كتاب فقه الرضا (عليه السلام) هكذا: “نروي أنّ في وصايا الأنبياء صلوات الله عليهم اصبروا على الحق وإن كان مّراً”.
وهنا يبدأ الإمام حديثه بقوله “نروي”، وهذا يدل على أنّه ميراث نُقل لأهل البيت (عليهم السلام)، وهم قد سمعوه من آبائهم وأسلافهم، وهم ينقلونه بدورهم ويوصون به غيرهم. وجملة “أنّ في وصايا الأنبياء” تعني أنّ وصية الأنبياء (عليهم السلام) لورثتهم وأتباعهم وحملة أمانتهم وإلى تلاميذ مدرسة الوحي هو هذا الدرس: “اصبروا على الحق وإن كان مُرّاً”. وهي عين الجملة التي نقلها أتباع الأئمة المعصومين (عليهم السلام) دون زيادة أو نقصان. ولعل هذه الجملة هي أقصر ما دل على أهمية الصبر، وفي نفس الوقت لها مغزى ودلالة كبيرة تفوق غيرها.
وبعد هذا الاستعراض لأهمّية الصبر، ننتقل للتعرّف إلى موقع هذه الخصلة النفسية ودورها داخل مجموع المعارف الدينية بحيث إنها استحوذت على هذا القدر من الاهتمام عند أولياء هذا الدين وأئمته.
موقع الصبر داخل التعاليم الإسلامية
قبل الدخول مباشرة في الحديث عن موقع هذا المفهوم، أريد أن أبيّن المقصود من “الموقع” داخل المفاهيم والتعاليم الدينية.
أول شيء هو أنّ الدين يمثل مجموعة المعارف والأحكام الحقوقية والأخلاقية. وهو يقوم على أسس فكرية يعبّر عنها بالرؤية الكونية التي يحملها عن العالم والإنسان. كذلك يتضمّن الأصول العملية التي تنبع من تلك الرؤية، وتبيّن طريقة تعامل الإنسان وسلوكه (الأيديولوجية العملية). ثم يحدّد العلاقات الضرورية للإنسان، أي علاقته بالله وبنفسه وبغيره من البشر، وبالموجودات الأخرى في إطار تلك الأصول العملية، ويتضمّن وفق ذلك، مجموعة من الأوامر والتعاليم الأخلاقية التي تؤدّي إلى التكامل الواقعي على أساس السعي والجدّ، وذلك للنجاح في المجالات المختلفة للحياة الإنسانية المحتاجة في مسيرتها التكاملية إلى مثل هذه الأوامر والتعاليم. ولاشكّ أنّه في مثل هذا المذهب الاجتماعي توجد مسائل فردية (أي ما يرتبط بشكل مباشر بمصالح الفرد الشخصية)، وقضايا اجتماعية ترتبط بالجماعة البشرية وجماعة المسلمين.
وإذا رجعنا إلى نقطة البحث الأساسية، نسأل: ما هو دور الصبر وأثره ضمن هذه المجموعة من المعارف والمقررات التي تشكل الدين؟ وبعبارة أخرى، ما هو دور الصبر في تكوين الإنسان الذي آمن بالدين، بمعنى ما يجب الاعتقاد فيه من أصول وعقائد، والتزام بمقرراته وتعاليمه في العمل، وامتلاك الخصائص الأخلاقية التي دعا إليها هذا الدين؟
في الأشكال الهندسية ـ مثلاً ـ نجد أن للأضلاع والزوايا والانحرافات تأثيراً أساسياً في الشكل والتكوين. فما هو موقع الصبر وتأثيره في الشكل الهندسي للإيمان. وكمثال نقدُمه، إذا أخذنا حافلة نقل الركّاب التي صنعت لهذا الغرض، فهذه الحافلة إنّما تقطع المسافات الطويلة وتوصل الركّاب مع حوائجهم إلى المكان المطلوب بأمان لأنّ فيها وسيلة أساسية وهي المحرك. وهذا المحرك يحصل على قوة الدفع من خلال الوقود. فإذا جئنا إلى الصبر، يمكننا أن نعتبره محركاً لطائرة التكامل التي هي في موضعنا الدين الإلهي، أو الوقود الذي يدفع هذا المحرك.
فلو لم يكن الصبر موجوداً، لم يكن بالإمكان فهم منطق الدين الحق والسامي، ولما حازت معارفه التي تمثّل أرقى المعارف الإنسانية في العالم على موقعها هذا. كما أنّه من دون الصبر، لن يبقى الأمل وانتظار ذلك اليوم الذي ينتصر فيه هذا الدين، ولفقد المؤمنون به الثبات والقوة اللازمة. ولتوقف العمل بالتعاليم الدينية التي لا تريدها الغرائز البشرية الطاغية. وإذا فُقد الصبر يصبح الحديث عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الدين كلاماً لا معنى له. وهذا الاجتماع العالمي الذي هو الحج حيث يلتقي الناس من الأماكن البعيدة فإنّه سيتحول إلى مكان ساكن وخال، والحناجر المناجية في ظلمات الليالي ستخمد، وتفقد ساحة جهاد النفس بريقها وتنكمش عروق الحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي حيث يبتعد الناس عن الإنفاق في سبيل الله. فلولا وجود الصبر، لكانت كل القيم العملية والأخلاقية للإسلام كالتقوى والأمانة والصدق والورع تودع في عالم النسيان. وخلاصة ما نريد ذكره أنه بدون شيء اسمه الصبر في الثقافة الإسلامية لبقي كل شخص بعيداً عن الإنسانية والدين اللذين يتطلبان السعي والعمل وبذل الجهد، وهي أمور لا تتحقق من دون شرط أساسي، هو الصبر. فالدين هو العمل، والعمل بالصبر. وإنما ينفخ في تلك التعاليم والمقررات الدينية الروح والقوة ويجعل قطارها يتحرّك إنما هو الصبر.
وبالبيان الذي تقدّم، نستطيع أن نفهم مغزى ومفاد هذا الإلهام الإلهي الذي وصلنا عبر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ـ باختلاف يسير في بعض الألفاظ من راوٍ إلى آخر ـ “الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد”(2). فالرأس له خصوصية بالنسبة للجسد في أنّه أساس وعماد الحياة، ومن دونه لا يبقى أيّ معنى للجسد ـ بينما إذا فقد الجسد أيّ عضو آخر من أعضائه الظاهرية كاليد والرجل و… فإنّه يبقى حياً. لكن الرأس الذي هو مركز القيادة والأوامر للأعصاب إذا فُقد وأُصيب بشلل تُصاب كلّ أعضاء البدن الأخرى بالشلل. ومن الممكن أن تبقى هذه الأعضاء حيّة ولكن لن تقدر على القيام بأيّ عمل أو تأثير. وعندها لن يكون هناك أيّ فارق بين حياتها وموتها. نحن نرى الأهميّة الكبرى للأدوار التي تؤديه الأعضاء كالعين اليد والرجل.. وهذا ما نلمسه بشكل واضح، ولكن كل ذلك إنّما هو بفضل وجود الرأس.. وهكذا الأمر بالنسبة للصبر.
فعندما يُفقد الصبر، لن يبقى التوحيد ثابتاً، وكذلك النبوة وبعثة الأنبياء، فإنها لن تُحقق ما تصبو إليه، ولن تتمكن من تأسيس وبناء المجتمع الإلهي الإسلامي، واستعادة حقوق المستضعفين. بل إنّ الصلاة والصيام وسائر العبادات ستفقد الأساس والقاعدة التي تحتاجها. وعليه نجد أنّ الصبر يهب تلك الاعتقادات والغايات الدينية والإنسانية روح التحقق. ولو لم يثبت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بداية البعثة على القول الحق، ولو لم يقف ثابتاً في مواجهة تلك الموانع والصعاب التي وقفت سداً أمام الإسلام، فمن المعلوم أن الإسلام لم يكن ليتجاوز أربعة جدران، أي بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه. أما شعار “لا إله إلا الله” فكان مصيره الزوال والانحسار.
إن الشيء الذي حفظ الإسلام هو الصبر. ولو لم يصبر أولياء الله وأنبياؤه العظام لم يكن ليصلنا أي شيء عن التوحيد. فالعامل الذي صان النداء الإلهي، وجعل حبل التوحيد متماسكاً وثيقاً، والذي سيحفظه إلى يوم القيامة أيضاً هو صبر حملة رايات هذا الفكر.
فإذا لم تترافق المعتقدات والآمال البشرية مع صبر المعتقدين والمنادين بها، فإنّها لن تتجاوز اللسان، وتزول على أثر تلاطم أمواج حوادث التاريخ. وهكذا يتضح مفهوم “الصَبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد”. وقد أشار أمير المؤمنين “عليه السلام” إلى ذلك في خطبته القاصعة في تحليله لثورة المستضعفين وانتصارهم على الطغاة، فيقول:
“حتى إذا رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبته، والاحتمال للمكروه من خوفه، جعل لهم من مضائق البلاء فرجاً، فأبدلهم العزّ مكان الذلّ، والأمن مكان الخوف. فصاروا ملوكاً حكماً، وأئمة أعلاماً، وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم تبلغ الآمال إليه بهم”(3).
هذه سنّة تاريخية وخالدة إلى الأبد، على هذا النحو. والصبر سيبقى على هذا الأساس سرّ ورمز تحقق المعتقدات الفردية والاجتماعية للدين في أهدافه القريبة والبعيدة.
مواطن الصبر
من خلال تفسير الصبر والذي اختصرناه بهذه الجملة القائلة بأنّه المقاومة لكل العلل والعوامل الموجودة للشر والفساد والانحطاط، يمكننا أن نمدد دائرة الصبر والمواطن التي تتطلب التحلي والتمسك بها. ومن الواضح في القرآن والأحاديث الشريفة أنّ الصابر المتمسك بالصبر قد وُعد بأجر عظيم في الدنيا والآخرة. ومن جهة أخرى لاشكّ بأنّ الذين يقفون مقابل حمَلة نداء الحق والعدل من الأبطال طليعة جيش الإسلام، والذين يلوثون أنفسهم في طاعة أربابهم النفعيين في ساحة هذه المعركة، والذين يحاربون دعوة الحق من أجل تحصيل المال والزاد والجاه، والذين يصدون عن الحق ويعارضونه انطلاقاً من أهوائهم، إنّ كلّ هؤلاء يشتركون مع الصّابرين على طريق الحق باسم ولفظ الصبر. هؤلاء قد يطلق عليهم لفظ الصابرين، ولكنهم بعيدون كلَّ البعد عن معنى الصبر. لأنّ كفاحهم وتحملّهم، لا يصبّ في طريق تكامل الإنسان، بل على العكس من ذلك، إنّهم لا يواجهون الأمور الباعثة على الشر والفساد والانحطاط، بل يقفون مقابل تجلّيات وإشراقات التكامل والسمو الإنساني ـ لذا فهم خارج دائرة مفهوم الصبر بالاصطلاح القرآن والروائي. لأنّ ميدان ومواطن الصبر الواقعي الحقيقي هو ميدان تكامل الإنسان.
فهناك، حيث الهدف الحقيقي لخلق الإنسان، والمقصد النهائي للإنسانية، وصيرورة المخلوق عبداً حقيقياً لله، وظهور الطاقات والاستعدادات الكامنة من خلال التحرّك والسعي، هناك يتجلى معنى الصبر وموطنه، حيث ينبغي المقاومة والثبات مقابل الدوافع والعوامل المانعة من هذا السعي والتحرّك. تلك العوامل الذاتية أو الخارجية التي تعرضنا لذكرها، والتي غالباً ما تترافق في تأثيرها وتكون مصداقاً لمكائد الشيطان. وعندما نريد أن نسلك الجادة الخطرة لأداء التكليف الشرعية، ونتعرّض للمضايقات والموانع المختلفة، كالموانع السلبية والموانع الإيجابية وغير المباشرة، كما في مثال المتسلِّق السابق، فإنَّه أثناء تسلّقه قد تكون مشاهدة المناظر الخلابة أو رفقة صاحب موسوس سبباً في إلقاء الحمل على الأرض، وتبدّل العزم على الصعود إلى الخمود والإخلاد إلى ذلك المكان الجميل. وأحياناً أخرى يكون المرض أو الانشغال بمريض أو تذكر أمور محزنة ومؤملة، باعثاً على فتور العزيمة وعدم مواصلة السير. وهذا الأخير مانع من نوع آخر وهو غير مباشر.
هذه الأنواع الثلاثة من الموانع تقف على طريق تكامل الإنسان. فإذا اعتبرنا أن الواجبات الدينية وسائل هذا المسير، والمحرمات هي حركة انحرافية فيه، وأن الحوادث المرة والمؤلمة في الحياة تؤدّي إلى عدم الاستقرار النفسي وفتور العزيمة، يمكن أن نقسّم الموانع عندئذٍ على هذا النحو:
أ ـ العوالم المانعة التي تؤدّي إلى ترك الواجبات.
ب ـ العوامل التي تدفع نحو فعل المحرمات وارتكاب الذنوب.
ج ـ والعوامل التي تجلب حالة عدم الاستقرار وعدم الثبات الروحي.
أمّا الصبر، فإنّه يعني المقاومة وعدم الاستسلام في مواجهة هذه العوامل الثلاثة، التي لاشكّ بأنّها تقف وراء الفساد والشر والسقوط. وبهذا التوضيح يمكننا أن ندرك عمق هذا الحديث الذي ينقله أمير المؤمنين (عليه السلام)عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
“الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية”.
وفي كل مورد من هذه الموارد الثلاثة، عندما تحدث الأمور والحوادث المؤلمة والمرّة في الحياة، وعندما يطلب من الإنسان القيام بتكليف ما، وعندما يدعوه أمر ما إلى ارتكاب معصية ما، فعندها يأتي دور ظهور قوة وبطولة الروح.
ولكي يتضح معنى هذا المصطلح الإسلامي بشكل كامل نأتي على شرح كل واحد من هذه الأمور الثلاثة:
الصبر على أداء التكليف
أمام كل تكليف أو واجب يوجد أنواع مختلفة من المصاعب والموانع. وهذا يعود إلى طبيعة الجهد المطلوب لأداء ذلك الواجب، وإلى روحية طلب الراحة في الإنسان.
فمن الواجبات والتكاليف الفردية الشائعة كالصلاة والصوم وما هو مطلوب كمقدمة لها، إلى الواجبات المالية والإنفاقات والحج والوظائف الاجتماعية المهمة والواجبات التي تتطلب بذل النفس والنفيس وترك زخارف الحياة، كل هذه الواجبات لا تنسجم مع طبع البشر، الذي وإن كان طلباً للرقي والكمال، إلاّ أنّه محب للراحة والسهولة.
وهذا الوضع موجود بالنسبة لجميع قوانين وأنظمة العالم سواء كانت سماوية أم وضعية، صحيحة أم سقيمة.
وفي الأصل، رغم أنّ القانون لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للإنسان، وعلى هذا الأساس يقرّ به، لكنه بشكل عام لا يراه حلواً ولا يستسيغه. وحتى تلك القوانين الوضعية المتعارفة في العالم، والتي لها نتائج جلية وواضحة من الناحية الإيجابية، والكلّ يعلم عواقب مخالفتها ـ كقوانين السير ـ فإنها لا تخرج عن هذه القاعدة التي ذكرناها. ومع أنّ آلاف الحوادث الدامية والمأساوية تقع بسبب التساهل في مخالفة هذه القوانين، وعلى مرأى معظم الناس، لكننا قلما نجد سائقاً لا ينزعج من الوقوف عند الضوء الأحمر أو عندما يجد إشارة تمنعه من اختصار الطريق من خلال المرور في هذا الشارع. مثل هذا الوضع موجود بالنسبة للقوانين الآخرة أيضاً.
فالتكاليف الدينية ـ رغم أنها شُرّعت على أساس الفطرة الأصيلة للإنسان وطبق الحاجات الواقعية له، وهي وسيلة لتكامله ورقيّه ـ عندما تنزل إلى ساحة العمل تُقترن بالصعوبة والمتاعب بغض النظر عن حجمها.
الصلاة ـ مثلاً ـ التي لا تتطلب من الإنسان سوى بضع دقائق، بالإضافة إلى ترك المشاغل الضرورية أو غير الضرورية، وتحصيل المقدّمات الضرورية كاللباس والمكان.. كل هذه الأمور مخالفة للطبع والميول النفسانية. وفي أثناء الصلاة، فإنّ تحصيل حضور القلب والتوجّه إلى أفعالها وأذكارها، وطرد كل الخواطر والواردات وكل ما يشغل عن الله، وإقفال أبواب الروح على الأفكار الطارئة، هي بمثابة شروط لازمة لكمال الصلاة وتحقق آثارها. وهي لهذا عمل مليء بالمشقة يستلزم قوة ورأسمالاً كبيراً.